بقلم الأديبة الكاتبة ليلى العثمان وقد نشرت هذه المقالة في جريدة القبس الكويتية
رحلـة إلـى اليمن.. (1)
استقبلني فجر صنعاء موشى بلون الشروق الخجول، شعرت بنداوة السماء تمسح هم الرحلة الطويلة، توقظ النعاس الذي لم تتح له فرصة لنوم مريح. خوفان كانا يتناوبان عليّ ويقلقان بالي. هذا الخوف ناتج عن أمرين:
أولهما قناعتي بـ «فوضى وزاراتنا العربية» وكثيراً ما اشتكى ضيوف الملتقيات الثقافية وغيرها في الوطن العربي من هذه الفوضى فينتظرون في المطارات حيث لا يجدون احداً في انتظارهم. ماذا لو حدث معي هذا وأنا المتعبة الجائعة الغريبة عن بلد لا تعرفني ولا أعرفها إلا بالأسماء؟ من سينقذني؟ وان كان لي فيها أصدقاء فأنا لا أعرف عناوين بيوتهم، وبعضهم لديّ أرقام هواتفهم لكنني لا أجرؤ على الاتصال فجراً لأزعجهم. سيتوجب عليّ اذاً ان اتصل بالجهة الداعية ـ مركز الدراسات والبحوث اليمني ـ لكن المركز لم يفتح بعد وسأنتظر أكثر من ساعتين وسيفسد عليّ هذا الانتظار صباحي وربما الصباحات القادمة كلها!
ظللت في قلقي وأنا انحدر من سلم الطائرة، وما ان نزلت الدرجة الأخيرة حتى صافحني اسمي مكتوباً على لوحة يرفعها أحدهم ويهديني تحية الصباح وترحيباً لطيفاً. شهق الفرح بداخلي وانتشرت أذرع الراحة تغذيني بعد جوع وتطرد القلق المسيطر.
دخلت صالة الشرف، استقبال يفتح شهيتي ان ارتمي على كل وجه لأشكره. كنت بحاجة لفنجان قهوة تركية ينشط نعاسي ويتناسب مع فرحي، فالقهوة بالنسبة لي رفيقة الفرح، وحين فاحت رائحتها تنشقتها بشهية عارمة، لكنني ما استطعت الا رشفة واحدة منها، فقد كانت «سكر زيادة» ومنعني خجلي ان اطلب غيرها. تعليمات ابي الصارمة تلاحقني «يا غريب كون اديب».
الخوف الثاني انني دائمة القلق من لقاء المدن للمرة الأولى، الوهلة الأولى، النظرة الأولى، الاحساس الأول، فالمدن كما البشر لها طبعائها المتناقضة، هناك مدن ترفضك، وهناك التي تفتح ذراعيها باتساعهما وتسقطك في وسط القلب. هي تحب أو تكره، تحتوي أو ترفض، تعد لك فراشاً أو تتركك تنام عند عتبة الباب دون لحاف.
هذا الخوف استعمرني منذ ان قررت السفر، وتمنيت بداخلي كثيراً ألا تصد صنعاء عني بوجهها ولا بعواطفها. فاستقبال المدينة إن كان كارهاً سيجعلني أبادله الكراهية ـ وهذا ما لا أريد ـ واستقبالها المحب سيفتح كل قنوات الحب اليها.
ركبت السيارة، الشمس لم تشرق كاملة بعد، لكن ضفائرها البرتقالية بدأت تتناثر من خلف الجبال وتصب ذهبها على أسطح البيوت الهاجعة. لا تزال الشوارع هي الأخرى لم تستقبل ضجيج الأقدام والعربات وعيناي تتأملان ما حولي في «لحظة حاسمة».
اهلا بك في صنعاء
عادة لا أحب المدن التي لا بحر فيها، كان هذا أحد هواجسي، فالبحر ـ هذا العشيق النادر الدائم ـ يأسرني. رائحة زفره تثير بروحي اشتهاءها للحياة رغم مصائبها، هو برأيي الرجل المتحرك، الثائر حيناً، الحنون أغلب الأحيان. هو الخائن الغدار وهو الوفي المعطاء. وحيث يكون البحر يكون الحب، يكون الأمان. فكيف سأقضي أيامي في صنعاء التي بلا بحر؟ خشيت ألا أحبها وخشيت أن ترفضني، ان تتعالى عليّ وهي التي بلا بحر، ان تضغط على روحي للدرجة التي أقرر فيها ان أعود من حيث أتيت، ولكن! يا لسعادتي فما ان جلست في السيارة ونسائم الصباح الباردة تلسعني حتى أحسست بذلك الشعور الرهيب، شيء ما يغمرني بحنان عذب، شيء ما يتسرب الى سمعي وكأنه صوت أمي التي غابت دون ان أودعها يهمس لي: «أهلاً بك في قلبي» أحسستها بذراعيها تحتوياني وتلصقاني بصدرها. آه ما ألذ ان تحضنك أم لحظة وصولك ونعاسك. ما أشهى ان تحس قبلاتها تدفئ وجنتيك وقلبها المفتوح يتسع لك كله، بهمومك الشاهقات التي لا ترى، بأحزانك الدامعات عصية الهطول وبفراغ قلبك رغم امتلائه.
صنعاء أحبتني منذ الوهلة الأولى ـ لاحقاً كتبها لي صديق بإهداء كتابه ـ صنعاء دعتني بإصرار ورفق ان أحبها منذ ان بددت خوفي من الانتظار. استللت أنفاس الراحة، انتشر بصدري التفاؤل كرذاذ بارد. تأكدت انني سأقضي الأيام سعيدة، وهيأت نفسي أن أرد جميلها منذ اللحظة الأولى، ان أنسف كل عوالق الهموم الباقية، ان أصفي ذهني ليكون مستعداً لاستقبال كل جديد من ثقافة، سياحة، معرفة ومحبة ايضاً.
لم أفكر يوماً بزيارة اليمن، حتى حين تسنى لي ان أرافق ذات مرة بعيدة وفداً من رابطة الأدباء رفضت السفر، لا أدري لماذا ـ وكم أنا نادمة الآن ـ ولا أدري لماذا حين نفكر بالسياحة لا نفكر بدول الجوار أو البلدان العربية البعيدة. لماذا نهرع الى دول العالم ونصطفيها متصورين انها الأجمل والأكمل والأوفى؟ ثم حين نزور بلداً لم نهتم ان يكون على خارطة اسفارنا نفاجأ ونشعر بالأسى من تقصيرنا.
هكذا جاءت الدعوة الى صنعاء لتكون فاتحة خير، فرصة ان أرى اليمن الذي لا أعرفه، فرصة اخرى ان اشارك في ملتقى أكبر ضيوفه الكاتب الالماني الكبير غونتر غراس، وفرصة ايضاً لألتقي بأصدقاء من اليمن وآخرين كثر يلبون الدعوة مثلي من ارجاء الوطن العربي.
اطمأننت انني أحببت صنعاء في اللحظة الأولى وهي أحبتني، فردت شراع روحي يحلق في فضائها وأنا أقطع الطريق الى الفندق، رغم الارهاق والنعاس والجوع كان حنان صنعاء يتبعثر عليّ فأدلل قلبي «آه يا قلبي لا تحزن».
وصلت الى الفندق ـ تاج سبأ ـ الذي ظللت أنطقه ـ تاج محل ـ فيضحكون عليّ، وحين خرجت في اليوم التالي لأتمشى صباحاً وأبحث عن مكتبة ابتعدت فضاع مني طريق العودة صرت أسأل المارة عن تاج محل، ولا أحد يعرفه حتى تنبه أحدهم وهو يغفر لي خطئي: «أنت غريبة، هو تاج سبأ» ورافقني حتى وصلت.
كعادتي لا يمكن ان أنام أو آكل قبل ان أفتح حقيبتي أو أرتبها، ثم اندسست في الفراش وغبت في نوم عميق لم أصح منه إلا في الساعة الثانية عشرة والنصف. ماذا ينتظرني في هذا الملتقى؟ بحثت عن الأخت الشاعرة أمل جبوري «لم أكن أعرفها من قبل»، هي المسؤولة التي يجب ان أراجعها، استلمت ملف الملتقى والبرنامج والتقيت ببعض المنظمين: الشاعر علي الشلاه والشاعر اليمني ـ الوديع ـ احمد العواضي وغيرهما مما سخروا أنفسهم لخدمة الملتقى وللضيوف.
عادة أكره الفنادق الكبيرة، أكره وجبات البوفيه المتشابهة، لكن ما يحدث اننا نخضع لهذه التقاليد الواردة، عادات استبدتنا وساهمت في ان تفرض علينا قوانينها فرضينا بها، بل ربما حرصنا عليها بعد ان «أترفنا النفط». كان الجوع اخذ مني مأخذه، فأكلت بشراهة ضاربة بالريجيم عرض الحائط.
«باب اليمن» يفتح باب
الحب والحسرة
كنت قد وصلت صنعاء قبل الوفود كلها، ذلك بسبب ان الطائرة اليمنية تغادر من الكويت يوم 7/1 أو ان أغادر على الطائرة الكويتية يوم 13/1 وتكون عندها قد بدأت فعاليات الملتقى. لذلك غادرت مبكرة وكان هذا من حظي لأكون حرة في الأيام الأولى، ألتقط ما اشتهيه من جولات في المدينة القديمة وأسواقها. ويا لتلك المدينة وأسواقها، فلا تلوموني ان كتبت بهذا العشق عن اليمن، ففي قراها البعيدة وأحياء صنعاء القديمة ببيوتها الطينية المتلاصقة شبه كبير بالكويت القديمة. تلك البساطة في البناء، الروح الخالية من سيطرة الحديث والتزويق المفتعل، ثوبها القديم يطغى بلونه ورائحته وعفويته. الأطفال يملأون الأزقة الضيقة يلعبون حفاة احرارا من التجمد امام الانترنت وغيرها من الألعاب التي فصلت أطفالنا عن حصن الأهل. حظائر المعيز والأبقار والدجاج قرب البيوت تفوح روائح خيرهم، والنساء جالسات على دكة البيوت تواكب أنظارهم فلول السياح القادمين المنبهرين بكل شيء.
ــ
بيت ماركو وعرس الشيراتون
دعتني الصديقة الشاعرة أمل جبوري لسهرة في بيت سبق ان تعرفت عليه في زيارتها السابقة، اعتذرت بأنني لست مدعوة، فأنا انتقد من يدخل بيوت الناس بلا دعوة أو يفرض نفسه في ملتقى ثقافي دون دعوة، وهذا يحدث من بعض الكاتبات بالذات، مما يحرج المنظمين ويزعجهم، لكنها أكدت لي ان صاحب البيت قال لها ان تدعو من تشاء. وحمدت الله انني وافقتها ورافقتها، فقد عبرت بي الى أجواء ساحرة في بيت ماركو العجيب.
وماركو هذا خبير ايطالي في فن العمارة الطينية، يعيش لسنوات طويلة في اليمن، فقد كان والده طبيب الامام الخاص. اختار هذا البيت الرائع بطرازه اليمني القديم، ولم يفسده بأثاث حديث. لا نجد سوى: المطارح، الوسائد والسجاد، حتى معلقات الضوء سراجات قديمة. وتوزعت على الطاولات شمعدانات قديمة بشموعها التي أضفت جواً رومانسياً. امتلأت ارجاء البيت ذي الطوابق الثلاث بتحف نادرة خشبية وفضية، أبواب قديمة، صناديق، أوانٍ ومرايا ولوحات.
انه بالفعل متحف يحوي حضارة اليمن وتقاليده، لا مكان لأي جديد تنفر منه العين ويكسر جماليات العمارة، الحركة تغدو صعبة لكثرة الأشياء، حين تجولت فيه أرهقني السؤال: كيف تتم عملية التنظيف خاصة ان زوجته لا تشاركه الإقامة في اليمن. لم أترك السؤال يرهقني ـ كعادتي ـ سألته فضحك طويلاً قبل ان يجيبني:
يحتاج البيت لشهر كامل لتنظيفه لذلك تتغير العاملة في بيتي سريعاً، لا أحد يحتمل هذه المشقة.
كان ضيوف ماركو كثيرين ومن جنسيات مختلفة ومن أهل اليمن. كان د. عبدالكريم الأرياني ـ المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ـ وكان مدير المتاحف والسفير الالماني وسيناتور صقلية وابنته المستشرقة فرانشيسكا قوراه وخليط العرب والفرنسيين والنمساويين والألمان، بعضهم عشق اليمن واستقر بها، وبعضهم يتواصل سنوياً بالزيارات اليها لشدة اعجابهم وعشقهم لها.
وإن كان ماركو قد تشبع بالطبائع العربية وأتقن اللغة الا انه تمسك بعادة من عادات الأجانب الجميلة، فالمائدة بسيطة رغم تعدد أصناف الطعام، لا بذخ ولا إسراف في كميات الأكل. كان تعليقنا ـ نحن العرب ـ انه لو كانت الدعوة في بيت عربي لطبخ أضعاف عدد المدعوين وأسرف. لقد أكلنا جميعناً وشبعنا وفاض القليل ايضاً.
عرس نسوي
في الليلة ذاتها كانت أمل مدعوة الى عرس يمني وطلبت مني ان أرافقها، وقبل ان اعترض أكدت لي انها اتصلت بأهل العرس ورحبوا بحضوري. كانت فرصة ذهبية لي ان أرى طقوس العرس اليمني لكن فجيعتي كانت كبيرة، إذ كان الحفل بالشيراتون، ولا شيء من الطابع القديم، لا الغناء ولا الرقص، ولا حتى ثوب العروس وبدلة العريس. وأكثر ما أحسست به من حرج ان العرس كان ـ نسوياً ـ وكل النساء منقبات بالسواد ما عداي، ما جعلني أبدوا نشازاً. وأسفت انني تركت بيت ماركو الذي اشاع الفرح والراحة بروحي، فقد قتل عرس الشيراتون تلك الفرحة.
في الليلة التي وصل بها وفد «مؤتمر الديموقراطيين العرب» طلب من منظمي «ملتقى الرواية العربية والالمانية» ان ينتقلوا بوفدهم الى فندق آخر يبعد عن قلب المدينة وحركة أسواقها.
شعرت بالحقد ان يحتل السياسيون مكان المثقفين ولم أخجل ان أبدي استيائي وأنا أرافق وفداً عربياً في المصعد، فاعترض أحدهم: وهل تتصورين ان الوزراء غير مثقفين؟ قلت: قليل من الوزراء العرب ـ خاصة وزراء الثقافة ـ من يتسمون بذلك. هناك اعتبارات عديدة لاختيار الوزراء لا تكون ثقافتهم من أولوياتها. وبقدر استيائي من تغيير الفندق لأن هذا سيضطرني لمحنة إعادة أغراضي الى الحقيبة ثم إعادة ترتيبها هناك إلا انني ـ ورغم حقدي على الوزراء المحتلين ـ شكرتهم بحرارة حين وصلت واستقررت بالفندق الجديد «فندق شهران» الواقع في ضاحية «حدة» احدى ضواحي صنعاء الهادئة، والذي يحوي 35 غرفة فقط، وهو مبني على الطراز اليمني القديم وفيه كل ما قد يتمناه الانسان في الفنادق الكبيرة من الابرة حتى الانترنت.
في مدخل الفندق تجلس «شرطيتان» يمنيتان مهمتهما تفتيش الداخلين، كان الوفد معفيا من التفتيش، ولو فُرض علينا لما اعترضنا عليه، فمصائب الارهاب التي انتشرت في وطننا العربي والعالم بأشكاله المتعددة يجعل الاحتياط واجبا. كنا نشعر بالأمان دائما، ليس بسبب التفتيش ولا لأن سيارات الشرطة تتقدم الحافلات لتفسح لنا الطريق، بل كنا نشعر به لسبب واحد، ان اليمن بلد آمن نتجول فيه ليلا كمثل النهار دون خوف حتى وان تأخر بنا الوقت، وكان هذا الاحساس بالأمان مريحا تماما كما واني في الكويت الآمنة.
لفت نظري ونحن في الطريق الى فندق شهران، ذلك الجبل الغريب المنقسم وكأنه صدر امرأة، فقيل لنا ان هذا المكان يدعى «النهدان»، نسبة لشكل هذا الجبل، وهناك مكان يدعى «الردفان»، لا بد ان جبله يشبه الردفين، وآخر يدعى «العيبان»، ولا ادري ما اقترفه جبل ذلك المكان من عيب؟ ومكان آخر يدعى «الكوكبان»، ربما لأن جبله برأسين يضيئان كالكوكب، اسماء فيها شاعرية الضوء والجنس والجمال، واي جمال أحلى ان تُشبه الجبال بالنساء والكواكب، وقد لفتني ان الاسماء على وزن «إنسان» أكيدا ان الإنسان اليمني الذي لم يفقد انسانيته البكر ولا عذوبة روحه يستحق هذا البلد رائع الجمال، اللهم لا حسد.
زيارة المقالح
يوم السبت كان يوما مميزا، في الساعة العاشرة صباحا قمنا بزيارة الى مركز الدراسات والبحوث اليمني الذي يرأسه الشاعر الكبير د. عبدالعزيز المقالح ، والداعي ايضا لهذا الملتقى، هذا الشاعر العذب الذي كان حريصا على الالتقاء بكل وفد يصل حتى وان كان في وقت متأخر من الليل يأتي الفندق، يرحب بنا ويثلج قلوبنا بهذا الود، كان حريصا على راحة الوفود، لم نشعر بأي نقص أو تقصير او ازعاج، كل الموظفين كانوا نشطاء في تحقيق الراحة والسعادة لكل فرد منا.
استقبلنا د. المقالح في مكتبه بهدوئه الشديد وبحزنه الذي أثار فضولي، حزن شفيف يبدو من العينين وفي الصوت، هل هو حزن الشعراء ام حزن الإنسان؟ هل هو حزن ولد معه واعتاده أم هو حزن سببته ويلات الحياة وهمومها؟ فضولي يتعبني في كثير من الأحيان بل يقلقني ويلح عليّ، فان أرضيته بطرح الأسئلة وسمعت الاجابات أخرسته وارتحت منه، وان لم احقق له هذا يظل يقلقني وقد تمضي شهور وسنوات قبل ان يلقى الاجابات وارتاح منه.
بعد ان شربنا القهوة اليمنية والشاي في مكتبه، قمنا بجولة في ارجاء مكتبة المركز المليئة بكل أصناف الكتب، قديمها وحديثها، عطور الثقافات من كل الجهات والاتجاهات الفكرية، عربية وعالمية تثير عبقها فينتشي العقل حتى دون ان يتيح الوقت فرصة لتقليب كتاب أو قراءة تعريف على الأغلفة الأخيرة، شعرت بالحزن، والمسؤول عن المكتبة وأرشفتها يقول لي: ليس لدينا شيء من كتبك، فأعلمته أنني احضرت معي مجموعة كاملة مهداة إلى المكتبة، وطمأنت نفسي ان كتبي ستحظى بالشرف الكبير حين تجد لها مكانا بين روائع ابداعات الإنسان من كل مكان.
ــ
سوق باب اليمن
اليمني أبي النفس رغم حاجته للزبون، إن دعاك وتجاوزت حانوته فلا يغضب، وان دخلت عنده ولم تجد حاجتك يدلك بصدق على حانوت آخر يبيع البضاعة التي تريدها. ولا يخلو طبع اليمني من الطرافة والفطنة فهو ذكي بالفطرة يفهم الإشارة بلبابة نادرة، وهو مثله مثل كل «فحولات الرجال العرب» يعشق الجمال، يهدي كلمات الغزل الجميل لكن دون وقاحة ولا خروج عن الأدب، ولا يستغل الزحام لتمتد كفه بحركة شائبة.
ما ضايقني في البدء أنهم حسبوني أجنبية فكان الغزل بلغات عديدة التقطوها من السياح ورفعوا سعر البضاعة، وما ان تكلمت العربية حتى تغير الحال وأرضى غروري.
وفي السوق اليمني كما في الاسواق العربية القديمة الممتلئة بالسياح، الفصال في الشراء يجعل السعر غير ثابت، وان كان اليمني لا يتهاون مع السائح الغريب إلا انه مع العربي غير ذلك فهو كريم، وبعد ان تشتري حاجتك منه يقدم هدية صغيرة بحجمها، كبيرة في معناها.
سوق «باب اليمن» من الأسواق المذهلة التي لا يمكن لك ان تمل منها او تنساها، لا يمكن لشيء ان يعبر عينيك عبور الكرام، كل لقطة ترسخ جمالها في عدسة عينيك وانت تلتقطها بعدسة الكاميرا، كل جماليات البناء يتشبع بها وجدانك العاشق لكل قديم لم يفسد.
كل رائحة غريبة او أليفة تفوح من الحوانيت، من الأرض المتربة، من الناس الذين يمرون تزاحمهم ويزاحمونك، روائح لا تثير التقزز والضيق، وبصدق أقول لم تلفتني ظاهرة الروائح البشرية في اليمن كما يحدث في المدن والبلدان الاخرى، لم أنفر لأنني لم أشتم ما ينفر وان كان الشكل ـ الفقير ربما ـ يوحي بذلك. حيرتني هذه الظاهرة، وان كان من السخف ان أتحدث عنها، ظاهرة أحسها غيري من الوفود.
الزيارة لذلك السوق لا تشبعك، تجد نفسك مشدودا للتجول فيه ثانية. هناك أسواق اخرى تعج في الليل بروائح الخضرة والفواكه والبهارات ولا تفقد فيها إلا مقاهي الرصيف التي تقدم «الشيشة» ويبدو انها لا تلقى الاهتمام الكبير من اليمنيين، وقد يكون ـ القات ـ هو الأثير بطقوسه المعتادة، لكن إلحاح من يطلبها يتحقق لأن اليمني صاحب المقهى البسيط لا يريدك ان تغادر مقهاه ولك أمنية فيه لم تتحقق.
ــ
مقيل النساء..
لا يقتصر ـ مقيل القات ـ على الرجال وحدهم، ولأن الاختلاط غير وارد فقط اهتمت النساء بإقامة ـ مقائلهن الخاصة ـ التي يتجمعن فيها. هكذا دعيت وزميلاتي الكاتبات «لمقيل نسوي ثقافي» ضم العديد من المبدعات، شاعرات، قاصات وروائيات، فنانات تشكيليات، باحثات وأستاذات في الجامعة. أغلب تلك الوجوه كنا نلتقيها في ملتقى الرواية لكننا تشككنا بمعرفتهن داخل بيت المقيل فقد تغيرت الأشكال والملامح، في الملتقى محجبات ولا أثر للماكياج على وجوههن. وفي المقيل كان الجمال الالهي المستور يكشف عن نفسه بالملابس الزاهية وتسريحات الشعر.
ومقيل النساء لا يختلف عن مقيل الرجال، الجلوس على المطارح الأرضية، النبات يوزع بأكياس النايلون الشفافة بعكس مجلس الرجال حيث توضع مثل ـ مداور الجت ـ أمام الجلوس. «للمرأة دائماً تفانينها» وتبدأ النساء بالتخزين، بعضهن اعتدن عليه والبعض الآخر لا يمارسنه. البعض يؤكدن ان للقات مردوداً ايجابياً على المرأة أكثر من الرجل، والبعض لا يؤثر عليهن ويمارسنه بفعل العادة.
لم أجد رغبة في التجريب ثانية، لكن الإلحاح جعلني وزميلاتي نجامل الداعيات بشيء بسيط سرعان ما بصقناه.
ولا يقل مقيل النساء المبدعات عن مقيل الرجال المبدعين أهمية، فهن لا يسرفن الوقت كله للحديث الاعتيادي أو إلقاء الطرائف، بل يقرأن الشعر، يتبادلن الاصدارات، يناقشن كل ما يهم المرأة والمجتمع من قضايا. ثم لا يمنع الأمر من بعض الطرب والرقص «روحوا القلوب ساعة بعد ساعة» ولا حرام في ذلك.
قضينا ساعتين في مقيل النساء، وغادرنا الى الملتقى سريعاً، فقد كانت الجلسة الأخيرة وقراءة البيان الختامي بانتظارنا. عدنا محملات باصداراتهن الجديدة وهداياهن ايضاًمواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
- بلد عربي صاحب أجمل و أغرب صحراء بالعالم
- عروس البحر الاحمر باللباس الاخضر صور أبو مالك
- عمار ياعمان
- سلسلة الجزائر عشقي حديقة بن عكنون
- ثابت يطرح خطتة السياحية في صيف
- خبراء صنعاء
- عن الاردن بليييز
- السفر الى ليبيا
- استفسار لمن يذهب لتونس اول مره
- تطوير المناطق التنموية تطلق عطاء لإنشاء الكورنيش في البحر الميت
- اليوم عدت من اليمن براً واب فنادقها الفاخرة لا يوجد غرف محجوزة
- أنا من سوريا أريد أسافر الى تونس واريد المساعدة
- الاخوة خبراء الاردن يرجى المساعدة ؟؟؟؟؟
- رابط مهم لكل زائر الاردن شامل انجليزي
- من الكويت الي تونس عين دراهم طبرقه بنزرت الحمامات سوسة القيروان
- اول زيارة لتونس ارجوو افادتي
- تعرف على ولايات تونسيةحصريا تونسي
- مطلوب اسعار شقق تمرة الفندقية
- أي إستفسار أو مساعدة في الأردن انا هنا النشمي الأردني
- كم هل متى ؟؟؟؟

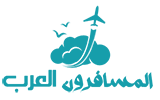




 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس
المفضلات